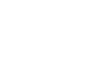إصلاح منظمة التحرير أم إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية
بقلم : رائد محمد الدبعي
يبدو أن معظم القرارات تحت شعار "إصلاح النظام السياسي" منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، جاءت نتيجة ضغوطات خارجية، جلّها أمريكي، ولم تنتج عن مراجعة وطنية أو مؤسسية للأداء العام، ولا عن ضغوطات داخلية، سواء كانت شعبية أو نخبوية، إذ أن تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأشخاص لا بالمؤسسة، بدءاً من الحاج أمين الحسيني، مروراً بأحمد الشقيري، ومن ثم الشهيد ياسر عرفات، وصولاً إلى السيد الرئيس محمود عباس، إلى درجة لامست التماهي ما بين الشخص والمؤسسة، وهو الأمر الذي يستوجب دراسة الأسباب الكامنة وراء استعصاء الحركة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها على الالتزام بالنهج المؤسسي، مع أنها بأمَسّ الحاجة له، لا سيما أمام تميز الحركة الصهيونية ببناء المؤسسات والارتكاز للتفكير الاستراتيجي منذ نشأتها، فقد ارتكزت الحركة الصهيونية منذ بداياتها الأولى على عدد من المؤسسات التي تحقق قاعدتها الثابتة "أرض أكثر لليهود، وعرب أقل عليها" مثل المنظمة الصهيونية العالمية 1897، والصندوق القومي اليهودي 1901، وصندوق الائتمان اليهودي للاستعمار في فلسطين1924، والوكالة اليهودية 1929، كما قامت بتأسيس مستشفى هداسا عام 1918، والجامعة العبرية بالقدس عام 1925، وقامت ببناء الكيبوتسات، وأسست مراكز بحثية، وأجهزة أمنية، وعصابات مسلحة قبل إنشاء إسرائيل بسنوات، لخدمة مشروعها، وهو الأمر الذي ساهم إلى جانب قضايا أخرى في تقدم المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي، وتحقيقه إنجازات متتالية، ففي الوقت الذي كانت تحقق الحركة الصهيونية تقدماً مضطرداً، بدءاً من بناء أولى مستعمراتها في منطقة السهل الساحلي عام 1878، مروراً بوعد بلفور، إلى تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية تغرق بصراعاتها الداخلية ما بين معارضة وموالاة، نشاشيبيون وحسينيون، من يعتمرون الكوفية، وخصومهم ممن يرتدون الطرابيش، تحت مسمى حزبي "العربي" و"الوطني" في ذلك الوقت، فيما كانت الأرض تنتزع من تحت أقدام أصحابها الأصليين.
عودًا على بدء، أقول "المطالب الأمريكية"، لأن الاتحاد الأوروبي لم ينجح حتى اللحظة في الانعتاق من السطوة الأمريكية واحتكارها الشامل لإدارة عملية التسوية، وكذلك توفيرها الغطاء العسكري والمالي والسياسي لعملية الإبادة الجماعية لشعبنا في قطاع غزة، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تقدمان 99% من السلاح الإسرائيلي الذي يقتل أطفالنا، كما أن 49 من أصل 87 فيتو أشهرتها الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945 كانت لحماية إسرائيل من قرارات تنتقدها أو تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضدها.
وبالتالي فإن المطالب الأوروبية بالإصلاح، والتي رافقت تأسيس السلطة الناشئة، أو تلك المرتبطة برزمة المساعدات الأخيرة، تفتقد لقدرتها على إحداث اختراق سياسي، نظرًا لتعقيدات إقرار السياسة الخارجية داخل الاتحاد، والتي تتطلب الإجماع، والذي يعتبر مستحيلاً في ظل تنامي القوى اليمينية والشعبوية في أوروبا وما أنتجته من انقسامات حادة داخل دول الاتحاد، وبالتالي، فإن كان توصيف الاتحاد الأوروبي بأنه عملاق اقتصادي به نوع من الصواب الجزئي، إلا أن وصفه بالقزم السياسي ليس بعيدًا عن الصواب، لا سيما في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي تتشابك فيه المصالح بعبء الماضي الأوروبي، وبالقراءات الدينية المشوّهة، وتخوف القادة الأوربيين من وصمهم بمعاداة السامية، والكفيلة بإنهاء حياتهم السياسية، على حساب الحق التاريخي للسكان الأصليين في الحرية والعدالة، فعلى الرغم من كل الغبار الذي تُحدثه أوروبا في المنطقة، إلا أنه يشبه ذاك المتولّد عن طائرة الهليكوبتر، التي تُحدث ضجة وغبارًا خلال تحليقها السطحي، دون أن تغوص في جذور الصراع الحقيقية، أو تُحدث أثرًا ملموسًا يقود نحو مقاربة سياسية تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
فيما ترى الأنظمة العربية بأن مصالحها تتجاوز أخلاقية الحق الفلسطيني، وهي إما غارقة في صراعات داخلية كما هو الحال في ليبيا والسودان ولبنان والعراق، أو مسلّمة بالسطوة الأمريكية لحد الانقياد، وبالتالي فكل ما نسمعه من لحن متعلق بالشأن الفلسطيني، سواء عزف على وتر عربي أو أوروبي، فإنه لا يتجاوز حدود النوتة والتأليف الأمريكي.
هدفت مطالب "الإصلاح" الأولى خلال انتفاضة الأقصى في مطلع القرن الجاري إلى تنحية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن المشهد السياسي، والتي بلغت ذروتها بتصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، بضرورة خلق قيادة فلسطينية جديدة لا تدعم "الإرهاب"، وما تلاها من ضغوطات عربية وأوروبية قادت نحو استشهاد الرئيس عرفات وحيدًا في مكتبه المحاصر بالمقاطعة، ومن ثم ما عايشناه بعد نجاح حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، والتي ضغطت الإدارة الأمريكية لعقدها، ومن ثم رفضت نتائجها، والذي قاد نحو انقلاب وفّرت له الولايات المتحدة وإسرائيل كل مقومات الديمومة والاستمرار، بما في ذلك إصدار تعليمات لقطر لتمويله علنًا عبر مطار اللد حتى صباح السابع من أكتوبر، وما نعيشه اليوم من ضغوط تهدف إلى إعادة تشكيل النظام السياسي، عبر رفع يافطة "الإصلاح" من جديد، والتي قد تتوسع هذه المرة لتشمل تغييرات جذرية في المناهج الدراسية، والخطاب الإعلامي، وصرف مستحقات الشهداء والأسرى والجرحى، مرورًا بإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية والشرطية الفلسطينية، أو عبر تحجيم دور الطبقة الفقيرة والوسطى في الحيز العام، لصالح أقلية برجوازية جديدة، ترتبط مصالحها بالاحتلال، وتعمل – سواء عن قصد أو دون قصد – على خدمة مشروعه الاستعماري الإحلالي، على أمل تحقيق مكاسب أو نجاة فردية.
تعود نغمة إصلاح السلطة الوطنية لتطلّ برأسها من جديد، يعزف لحنها هذه المرة الأوروبيون والعرب، بينما تُقاد من قبل الإدارة الأمريكية، التي تتبنى اليوم مقاربة جديدة تقوم على التعالي عن التعاطي المباشر مع القيادة الفلسطينية، وتبنّي رواية اليمين الصهيوني الديني في إسرائيل، وتجاوز طرح مبادرة جديدة كما فعل ترامب خلال فترة رئاسته الأولى ضمن ما أطلق عليه "صفقة القرن" أو "المشترك الإبراهيمي"، نحو تطبيق رؤاها في المنطقة بمعزل عن الموقف الفلسطيني، في ظل مآلات الأحداث في غزة ولبنان وسوريا وإيران، والتي ترى بها الإدارة الأمريكية وإسرائيل فرصة قد لا تتكرر نحو حسم الصراع بدلاً من إدارته.
تتزاحم المبادرات التي ترفع شعار الإصلاح، أو إعادة تصويب المسار الوطني العام في فلسطين، سواء عبر المطالبة بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر إعادة بنائها على أسس ديمقراطية صلبة، كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في قطر في شباط المنصرم، أو إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن خطة تقودها حكومة الدكتور محمد مصطفى، والتي لا يمكن فصلها عن مطالب المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي ربط مساعدته الأخيرة والبالغة 1.6 مليار بإصلاحات داخلية، أو تصريحات السيد الرئيس محمود عباس في مؤتمر القمة العربية الأخير بالقاهرة، عزمه إقرار منصبَي نائب رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية ولدولة فلسطين، ودعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية – الذي أُوكلت له صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني – للانعقاد حصريًا لإقرار الموقعين في النظام السياسي الفلسطيني، على الرغم من إصداره إعلانًا دستوريًا بتاريخ 27-11-2024 يقضي أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، مبرّرة تلك الأسئلة التي تُطرح حول جدوى تلك المبادرات والقرارات، ومشروعة كل الأصوات التي تستفسر عن أثرها الحقيقي على حياة المواطن الفلسطيني المسحوق في غزة أو القدس أو الضفة، أو على أربعة عشر مليون فلسطيني في الوطن والمنافي. ومباح هو السؤال عن قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي على النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، أو حمايته من مخططات الإلغاء والتهجير الصهيونية، ومُقَرّ هو السؤال حول فعالية تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين في تعزيز مقومات صمودنا وبقائنا على الأرض، وعقلاني هو الطرح أن الأولوية يجب أن تنصّب نحو إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، تلك التي تحافظ على الهوية الوطنية الجامعة، وتتوافق على أشكال النضال التحرري، وتعيد تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، بالعودة إلى أصله، والمتمثل بالحرية وتقرير المصير، وقبل كل ذلك إعادة بناء عمودها الأساسي المتمثل بالقوى والفصائل الفلسطينية والمنظمات الشعبية الفلسطينية والاتحادات الفلسطينية
لا يحتاج المرء لأي حصافة أو ذكاء لملاحظة مدى تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية، بدءًا بالاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية، التي تعيش حالة من الشيخوخة والتراجع، باستثناء بعضها الذي يعقد انتخاباته بشكل منتظم وشفاف، كما لا يمكن إغفال أثر الانقسام الفلسطيني عليها داخل الوطن وخارجه، يضاف أن واقع الفصائل والقوى الفلسطينية لا يقلّ إيلامًا عن الاتحادات والنقابات، إذ أن حركة فتح، التي تُشكّل اليوم، لأسباب موضوعية وذاتية، حجر الأساس للنظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية خصوصًا، وأملًا للفلسطينيين في تعزيز صمودهم وبقائهم على الأرض، كونها إطارًا وطنيًا جامعًا يحتمل الاختلاف والتنوع والاجتهاد، ويتمتع بالقبول الدولي، والامتداد الأفقي داخل المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، ليست هي فتح ذاتها التي عاشت مع المواطنين خبزهم ووجعهم وتضحياتهم وآمالهم خلال العقود الستة الماضية، والتي ضمّت الفلسطينيين والعرب، والأجانب، ومعتنقي جميع الأديان السماوية والأرضيّة، والطلبة، والشباب، والنساء، والشيوخ، والأشبال، والمتدينين والعلمانيين، والعقلانيين، والمتحمسين، ودعاة الفكر المحافظ، وأولئك الذين آمنوا بضرورة الاستلهام من التجربة الاشتراكية اللينينية، والذين أسّسوا الكتيبة الطلابية واختلفوا مع ياسر عرفات، فناقشوه صباحًا، واحتدّ النقاش مرارًا، لكنه كان يثق ببنادقهم لحمايته وحراسة مكتبه البعيد عن معسكرهم عشرات الأمتار ليلًا، ولا هي ذاك الأفق الذي اتسع للتنوع والاختلاف والاجتهاد، ودخلت كل خيمة لجوائ، ومخيم في الوطن والشتات، وكل مدينة وقرية وحي وبيت فلسطيني وعربي، والتي قال فيها نزار قباني أجمل قصائده "فتح"، ولا هي الحركة المتجددة والشابة التي تعكس تنوع المجتمع الفلسطيني، إذ يقود اليوم مؤسساتها الحركية، ويتقلد مواقعها التنظيمية، مجموعة من المواطنين، جلّهم من طبقة الموظفين المدنيين والعسكريين، الذين يحدّ من قدرة معظمهم على التعبير عن آرائهم بصراحة وحرية، طموحاتهم الفردية في تحسين ظروفهم الوظيفية، يُضاف إلى ذلك كل الحصى الراكدة بمياه فتح منذ أوسلو حتى اليوم. وبالتالي، فإن إصلاح فتح وتوحيد صفوفها، وإعادة بنائها عبر احتضان كل أبنائها، على اختلاف اجتهاداتهم وقدراتهم وتنوعهم، وضرورة انفتاح الحركة على شعبها، سواء على النخب أو الجماهير، والذين يحملون حبًّا وعتبًا كبيرًا على فتح، وكذلك عودة فتح لقيادة الميدان، عبر برنامج وطني مقاوم، يقوم على حشد كل طاقات شعبنا، ، كونها مؤهلة لهذه المهمة، بما تمتلكه من قدرات على الحشد والتوجيه إن هي أحسنت استثمار قدرات أبنائها، وفكرها المستنير، وعليه فإن إعادة بناء فتح الفكرة والحركة والرسالة، وتصويب علاقة الحركة بالسلطة، وتحررها من أعباء التزاماتها، باعتبارها وسيلة لا هدف، ومشروعا يجب تقييمه وتصويبه كلما وجب ذلك، يجب أن يتقدم على إعادة إصلاح منظمة التحرير.
أما حركة حماس، فهي تعيش حالة اغتراب حادة عن الواقع، فبعد الضربات الكبرى لمحور إيران في المنطقة، بدءًا من مآلات العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أظهرت فيه إسرائيل تفوقًا استخباراتيًا وعسكريًا صادمًا، إذ أشارت معطيات الميدان إلى امتلاك الاحتلال الإسرائيلي أجيالًا متقدمة من الأسلحة التدميرية، والقدرات الأمنية، في ظل سلاح عربي تقليدي متهالك، وكذلك سقوط النظام السوري، أو توجهات إيران نحو التفاهم مع الإدارة الأمريكية، وقبل كل ذلك الثمن الباهظ لعملية السابع من أكتوبر، والذي لا تستطيع حركة حماس الهروب من تحمّل المسؤولية عن نتائجه، كونها خططت ونفذت بشكل منفرد، وتفاوض اليوم على إنهاء الحرب في قطاع غزة بمعزل عن الكل الفلسطيني، وبالتالي، فإن مطالب المواطنين والنخب السياسية والمجتمعية لحركة حماس بقراءة أكثر واقعية ومنطقية للواقع، وإعادة بناء الحركة على أسس تتوافق مع معطيات المرحلة، يجب أن يتقدّم على تمسّكها بحكم غزة، أو إصرارها على التنكّر للواقع، متجاهلة حقائق الميدان ومعادلات القوى الجديدة بالمنطقة، إذ إن حركة حماس مطالبة اليوم بإعادة النظر بمسيرتها خلال العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك منهاجها التربوي لأبنائها، والذي لا زال حبيسًا بمنهج المدرسة الإخوانية الأولى ممثلة بحسن البنّا والسيد سابق، وأفكار سيد قطب، والأفكار السلفية الاعتقادية، ومدرسة ابن تيمية بعد إخراج فتاويه من سياقها المكاني والزماني، وتبنّي موقف الإخوان المسلمين في موضوع الحكم والإمامة والسياسة، وكذلك علاقاتها الإقليمية، وارتباطاتها بإيران، والتي أثبتت أنها عبء ثقيل على شعبها ومصالحه الوطنية، من واجب حماس اليوم أن تنتصر للوطنية على حساب الفئوية، وأن تعيد تقييم المرحلة السابقة بعقلانية وحكمة وواقعية، وهذا يجب أن يتجاوز أية أولويات أخرى.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فلا تزال تتقوقع داخل ذراعها العسكري، على الرغم من امتلاكها قبولًا شعبيًا حقيقيًا، وفكرا رحبا، يُمكنها من لعب دور سياسي ومجتمعي واسع، كما أن علاقتها بإيران تحتاج إلى مراجعة استراتيجية عميقة، تنسجم مع تضحياتها كحركة تحرر وطني، قدّمت ولا تزال تقدّم التضحيات، دون أن تتورط بالدم الفلسطيني، كغيرها من الحركات الإسلاموية في فلسطين.
أما قوى اليسار الفلسطيني، فيمكن تقسيمها من حيث الحضور الجماهيري إلى فئتين، تتكوّن الأولى من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، إذ أن لتلك القوى حضورها النسبي على الساحة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يُلاحظ في حضورهم على الساحة الأكاديمية والفكرية، وحضورهم النسبي بالميدان، إلا أن تلك القوى تعتاش عمومًا على تاريخها الثوري، وميراث قادتها المؤسسين، إذ تعاني اليوم هذه الحركات من مجموعة مركبة من الأزمات، وفي مقدمتها غرقها بالتنظير على حساب البرامج، واغترابها عن المبادئ المؤسسة، إضافة إلى أزمة القيادة، وضبابية المواقف، وغياب الشخصيات الكاريزمية، وغرقها في صراعات أيديولوجية عقيمة على حساب الصراع الوطني الأساسي، واندفاع عدد من قياداتها نحو قيادة عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي ترتكز في تمويلها على الدعم الغربي الليبرالي الرأسمالي، في مشهد يدعو للسخرية والحزن في آن.
أما باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهي: منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية – الصاعقة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، فهي تعاني من مجموعة أكثر تعقيداً من التحديات، وفي مقدمتها عدم قدرتها على الاستقطاب وحشد الأعضاء، بل إن بعض تلك الفصائل، والتي لها تاريخ نضالي مشرف، تنحصر عضويتها بالمكتب السياسي وعشرات الأعضاء، فيما لا تستطيع تجنيد عضو جديد واحد في المخيمات أو القرى أو الأحياء، أو مؤسسات التعليم العالي التي تضم مئات الاَلاف من الطلبة، باستثناء العضوية الناشئة عن الميراث العائلي، كي لا يُتهم هذا الخطاب بالعمومية والتجني، يمكن الاطلاع على نتائج الانتخابات الطلابية والمحلية خلال الأعوام الماضية، والتي شهدت تنافسًا بين حركتي فتح وحماس، للاستدلال على مستوى الضعف الذي تعاني منه تلك القوى، كما أن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وعلى رغم تبنيها خطابًا مدنيًا وحقوقيًا ناضجًا، إلا أنها تفتقر لحضور جماهيري وتنظيمي فعّال، لا سيما في المخيمات والقرى والأحياء الشعبية، وتكاد تفقد قدرتها على الاستقطاب، نتيجة احتكار صورة المبادرة بأمينها العام الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي أصبحت صورته تغطي على المؤسسة نفسها، لا سيما مع افتقارها لفعل مقاوم ملموس ومؤثر، فبينما تؤكد المبادرة على المقاومة بكافة أشكالها، إلا أنها تمارس أسلوبا وحيداً، يتمثل في المقاومة السلمية اللاعنفية، وهو ما يجعل خطابها يفتقر إلى القوة الإقناعية، نظرًا لافتقاره إلى النموذج، وتقديمه للقدوة، وهو الأمر الذي يمتد ليشمل جميع الفصائل المذكورة أعلاه، والتي تفتقر ليس فقط إلى الرغبة، إنما أيضًا إلى القدرة على الفعل، يُضاف إلى ذلك أن ارتباط بعض الفصائل الفلسطينية بالنظام السوري السابق، وقبله بالنظام البعثي بالعراق، شكّل أحد أسباب ضعفها، وربما غيابها تمامًا عن المشهد السياسي الفلسطيني.
هذه الصورة البانورامية لواقع الفصائل الفلسطينية، التي تشكّل العمود الفقري للحركة الوطنية، تجعل من سؤال "هل يمكن إصلاح منظمة التحرير" في ظل هذا الواقع المأساوي، سؤالًا مشروعًا وعقلانيًا وجوهريًا، إذ لا معنى لبناء أجمل القصور على أسس متهالكة، لأنه حتمًا سينهار أمام أول هزّة.
علينا أن نعترف أن فصائلنا، دون استثناء، إسلاموية كانت أو وطنية، يسارية أو يمينية، بحاجة ماسّة إلى إعادة بناء شاملة، ومراجعة صادقة، وتصويب حقيقي للمسار، بدلًا من الاستمرار في البكائيات والتناحر على جلد الدب قبل اصطياده أو على سلطة دون سلطة، وعلينا أن نعترف أولًا أن الحركة الوطنية الفلسطينية بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإعادة البناء، واستجلاب العبر، والعودة للمبادئ المؤسسة لها، وتبني آليات النضال الأكثر مواءمة للمرحلة، بدلًا من البحث عن حلول ترقيعية لن تزيد الأمور إلا تعقيدًا وتأزيمًا.